 قالوا وقلنا
قالوا وقلنا
معنى أن تكون فنّاناً الآن!
بقلم: زاهي وهبي...
تسنّى لي، خلال مسيرتي المهنية، محاورة عدد هائل من كبار الأدباء والفنانين العرب في كل الميادين من مختلف البلدان العربية، ومن الأجيال كافةً، المخضرمة والجديدة وما بينهما. أستطيع الجزم بأن النجوم الحقيقيين، الذين تخطت شهرتهم حدود أوطانهم وكانت تجاربهم وأعمالهم عابرة للأجيال، ومثّلت أعمالهم ذخائر لا تفنى ولا تبيد، هم أولئك الذين انحازوا إلى الناس وإلى قضاياهم العادلة والمحقة، ووقفوا ضد الظالم ونصروا المظلوم، ولم يكتفوا بعّدّ الفن، على أنواعه، مجردَ وسيلة تسلية وترفيه.
إن عدنا بالذاكرة إلى الوراء، واستعدنا مثلاً الحروب التي شنتها "إسرائيل" وحلفاؤها على بلداننا العربية، لوجدنا أن معظم الأدباء والفنانين الكبار كان يسارع إلى تقديم أعمال تتماشى مع المرحلة، وتنتصر للوطن ضد أعدائه، بل يقيم الحفلات التي يعود ريعها لمصلحة المجهود الحربي، وتعزّز الروح القتالية والروح الوطنية.
هذا ما فعله سيد درويش وأم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وفريد الأطرش ونجاح سلام وشريفة فاضل وشادية وعبد الرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم ونزار قباني وأحمد شفيق كامل وصلاح جاهين وفيروز والأخَوان الرحباني وسواهم، ممن كانوا أصوات أوطانهم في لحظة الحقيقة. وهذا ما حدث في أثناء العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، وخلال الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967، وأيضاً في عام 1973، حين عبَر الجيش المصري قناة السويس، وخاض الجيش السوري معارك ضارية في جبهة الجولان.
مَن ينسى أغنيات مثل: أصبح عندي الآن بندقية (أم كلثوم)، خلّي السلاح صاحي (عبد الحليم حافظ)، النيل مقبرة الغزاة وسوريا يا حبيبتي (نجاح سلام) وأم البطل (شريفة فاضل) وسواها من أغنيات رسخت في ذاكرة أجيال، وشكّلت علامات فنية فارقة في لحظات مفصلية من تاريخ بلادنا العربية، التي مهما تقادمت الأيام وتبدلت الأحوال فإن مصيرها يبقى مترابطاً، حتى لو حاول الشوفينيون والمرجفون بثّ الروح القُطرية البغيضة، ومهما تكاثرت النكبات في هذا البلد أو ذاك. فأصل الداء واحد، وهو الكيان السرطاني الخبيث، الذي زُرِع في جسد الأمة من خلال احتلال فلسطين واغتصاب أرضها وجغرافيتها وتاريخها. فلو استطاع العرب مداواة النكبة الفلسطينية، منذ لحظة حلولها، لكنا تجنبنا النكبات اللاحقة التي أصابت معظم بلداننا العربية.
خلال الاجتياحات الإسرائيلية للبنان، وفي زمن الانتفاضات الفلسطينية، كانت أغنيات مارسيل خليفة وأحمد قعبور وخالد الهبر وزياد الرحباني وجوليا بطرس وفِرق غنائية كثيرة تمثّل صوت المقاومين والثائرين، وتشدّ أزرهم، وترفع معنويات الناس حيث كانوا، وتساهم في تشكيل الوعي وتحصينه، مثلما تؤسّس ذاكرةَ المراحل المفصلية في مسيرة الصراع الضاري مع المحتل الإسرائيلي.
لنعترفْ، دارت الأيام وتغيرت الأحوال، وتصدّر المشهدَ التافهون والحمقى. طبعاً، لم يحدث هذا الأمر بصورة عفوية، بل هو نتاج ثقافة العولمة الاستهلاكية، والاشتغال الممنهج على تسطيح العقول وتزييف الوعي، مضافاً إلى ذلك في بلادنا استيلاد نوعين من التطرف: تطرف تكفيري إرهابي، وتطرف تمييعي استهلاكي. وليس من باب المصادفة أن تُخلى المنابر والشاشات تارة لخطاب التكفير وإثارة الفتن على أنواعها، وشحذ الغرائز الطائفية والمذهبية والعشائرية والجهوية، وطوراً لخطاب التفاهة والاستهلاك الخالي من أي قيم أو التزام، ولا سيما الالتزام الوطني أو القومي.
وفي رأي المفكّر الكندي آلان دونو أن "التافهين حسموا المعركة لمصلحتهم في هذه الأيام. لقد تغير الزمن، زمن الحق والقيم، ذلك بأن التافهين أمسكوا بكل شيء، بكل تفاهتهم وفسادهم. فعند غياب القيم والمبادئ الراقية، يطفو الفساد المبرمج، ذوقاً وأخلاقاً وقيماً. إنه زمن الصعاليك الهابط".
أتفق جداً مع صاحب كتاب "نظام التفاهة" في معظم ما سطّره في كتابه المرجعي القيّم، لكني لن أستسلم لفكرة، مفادها أن المعركة حُسمت لمصلحة التافهين. هي مرحلة انحطاط، بلا شك، تسلَّع فيها كل شيء، والفنون على رأس قائمة التسليع. لقد استطاع نظام العولمة جعل الفن نوعاً من "البزنس" عِوضاً من أن يكون نوعاً من الإبداع، بحيث "كلما تعمّق الإنسان في الإسفاف والابتذال والهبوط ازداد جماهيرية وشهرة".
انطلاقاً من هذا الواقع، لا نستغرب حين نرى أن مَن يتصدر المشهد اليوم هم فنانو التفاهة والرداءة، الذين لا يَعُدّون الفن سوى مصدر لجني المال، بعيداً عن كل قيمة جمالية وإنسانية. لكن الفنان الحقيقي، أياً كان مجال إبداعه، لا يمكنه أبداً أن يبقى متفرجاً على مذبحة غزة، ولا أن يصمت عن الصهيونازية التي تقتل الأبرياء، من نساء وأطفال وعجائز، وتبيد البشر والشجر والحجر. ولعل غزة، مثلما كشفت عورة "العالم الحرّ" وسوأته، فإنها تكشف أيضاً الواقع الرديء الذي يتّسم به كثير من الأداء الثقافي والفني، من دون أن يعني ذلك خلو الساحة من فنانين حقيقيين سارعوا إلى إعلان موقف داعم لغزة وأهلها وفلسطين وشعبها.
ليس المطلوب أن يتوقف أحد عن عمله، لكن في إمكان كل مؤثِّر أن يغتنم فرصة تأثيره كي يوصل إلى محبيه ومعجبيه رسالة وعي بما يحدث، ورسالة دعم لأبناء غزة، وهم يواجهون آلة القتل الوحشية. وهذا ما فعله كثيرون من نجوم العالم، من دون حساب الربح والخسارة. وحسناً يفعل كل مؤثِّرٍ عربيّ يكتب كلمة، أو ينشر صورة، أو يرفع صوته عالياً من أجل فلسطين. فالمعنى الحقيقي لأن تكون مبدعاً أو مؤثِّراً، في أي مجال أدبي أو فني أو اجتماعي، هو أن تكون إنساناً أولاً. وفلسطين هي المحكّ والمقياس.




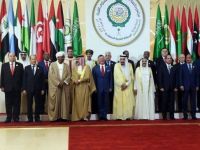
ارسال التعليق