 قالوا وقلنا
قالوا وقلنا
الترفيه والرياضة في #السعودية: تلميع صورة أم بناء هوية
بقلم: سلطان العامر ...
مؤخرا قدم نادي الهلال السعودي لكرة القدم قدّم عرضاً رسمياً لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقيمة 400 مليون دولار. وكان في حال قبول ميسي العرض، فإنه كان سيصبح ثاني نجم عالمي يوقع مع نادي سعودي بعد توقيع نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ديسمبر الماضي.
لا تقتصر الصفقات السعودية العالمية مع نجوم الكرة، بل تمتد لتشمل إقامة فعاليات ترفيهية ورياضية ضخمة، واستضافة قائمة طويلة من نجوم الغناء العالمي الذين قدموا للسعودية لإقامة مهرجانات تبدأ مع جانيت جاكسون، ماريا كوري، جاستن بيبر، ولا تنتهي مع مغني الأوبرا أندريا بوتشيلي وفرقة بي تي إس الشهيرة.
تنقسم ردّات الفعل إزاء هذا النشاط السعودي المتزايد في مجال الرياضة والترفيه إلى قسمين:
الأوّل احتفائي، يعتبره غير مسبوق ودليل إضافي على نجاح الحكومة السعودية في “تحرير” المجتمع السعودي من “انغلاقه”.
الثاني، وهو السائد في الدوائر الناشطة في مجال حقوق الإنسان، فيعتبره محاولة من الحكومة السعودية لتلميع صورتها وصرف الانتباه عن – ما وصفته منظمة العفو الدولية في تعليقها على التوقيع مع رونالدو – “سجل البلاد المروّع في مجال حقوق الإنسان”.
كلا هذين الموقفين قاصران ويغفلان السياق العام الذي يوجّه وتحدث فيه هذه الأحداث والفعاليات. وهذا السياق العام مرتبط بشكل رئيس ببرنامجين حكوميين يمثلان جزئين رئيسين من مشروع رؤية 2030:
الأول “برنامج جودة الحياة” ويهدف لتحويل المدينة السعودية والحياة اليومية فيها من مدينة خاوية ثقافياً ورياضياً وترفيهياً ومكبّلة بالقيود القانونية إلى مدينة “عالمية” مُمتعة تنافس غيرها من المدن العالمية على جذب السياح والاستثمارات والمبدعين.
الثاني، فهو “برنامج تنمية القدرات البشرية”، ويهدف لتحويل هوية وسلوك المواطن من مواطن ذي هوية محافظة يعتمد على الانفاق الحكومي من ريع النفط ليصبح، كما يصفه البرنامج، “مواطنا منافسا عالمياً”.
والمحرّك الرئيسي لهذه البرامج هو نفسه محرّك مشروع رؤية 2030: جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر الدخل، وتخفيف الإنفاق الحكومي. ومثل باقي برامج الرؤية، تدير هذه البرامج نخبة بيروقراطية جديدة ذات أيديولوجية إدارية لا ترى بأساً في تنفيذ أجندتها النيوليبرالية بتوسّل أدوات سلطوية لا تأبه برأي وإشراك المواطن الذي تريد تغيير حياته وهويته وسلوكه.
هذه البرامج ليست جديدة في تاريخ المملكة. ففي المجال الرياضي، وابتداء من عام 1992، أطلقت السعودية فكرة بطولة دولية لكرة القدم أسمتها بطولة القارات، ونظمت دوراتها الثلاث الأولى قبل أن يتبناها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتصبح ثاني أهم بطولة دولية في كرة القدم حتى عام 2019.
قبل التوقيع مع رونالدو بسنوات، كانت الأندية السعودية محطة في حياة عدد من نجوم كرة القدم العالميين، مثل بيبيتو وستويشكوف وويلهامسون. أما في مجال الترفيه، فالأندية السعودية لم تكن أندية رياضية فقط، بل ثقافية واجتماعية، وكانت الفضاءات الرئيسة التي نظمت فيها الأعمال المسرحية والحفلات الغنائية من الستينات وحتى منتصف الثمانينات الميلادية.
ومنذ نهاية التسعينات، بدأت المناطق والمحافظات بتنظيم المهرجانات الترفيهية والغنائية، كمهرجان أبها الغنائي ومهرجان جدة غير ومهرجان الجنادرية للتراث والثقافة إلى جانب الكثير من مهرجانات الصيف واحتفالات الأعياد المتنوعة في مختلف المدن.
عانت هذه البرامج والفعاليات من مشاكل كثيرة، فلم تكن مستدامة ولا قابلة للنمو وتنفذ بواسطة جهاز بيروقراطي متشظي يصعب عليه التنسيق أفقياً بين المؤسسات المختلفة أو مع القطاع الخاص وفي حالة توتر مع الهوية المحافظة التي كانت الحكومة تروجها عن نفسها وتفرضها على المجتمع في المدارس والإعلام والفضاءات العامة بالتعاون مع الحركات الإسلامية.
نتج عن هذا وضع معيشي متدنٍ مقارنة بالدول الأخرى المقاربة لحجم المملكة الاقتصادي. فالفروقات بين الذكور والإناث شاسعة في التنقل والتعليم والعمل والأحوال الشخصية، وخيارات الترفيه والفعاليات الثقافية محدودة، ووسائل النقل العام غير سائدة، والوفيات بسبب حوادث السيارة من بين الأعلى عالمياً، ومعدل بطالة السعوديين (وخصوصاً الإناث) عال.
تسبب هذا الوضع في خروج الأموال من المملكة، إما على شكل سياحة خارجية حيث حلّ سكان السعودية في الترتيب السابع عشر عالميا (بمقارنة نسبة السياح لعدد السكان)، والأول في الشرق الأوسط، إذ بلغ في عام 2015 عددهم 16 مليون مسافر بإنفاق يعادل 20 مليار دولار، و إما تخرج الأموال على شكل تحويلات خارجية للمقيمين في السعودية (39 مليار دولار في 2015).
لمعالجة هذه المشاكل بطريقة سلطوية ونيولبرالية، أطلقت الحكومة السعودية برنامجا “جودة الحياة” و”تنمية القدرات البشرية”، وحددت بشكل مفصل أهدافهما ومؤشرات أدائهما الكميّة.
فمن بين أهداف برنامج “جودة الحياة” نجد ما هو متعلق بالمدينة مثل “تحسين المشهد الحضري ” و”الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة”، ونجد أهدافاً رياضية مثل “تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع” و”تحقيق التميّز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً”، وأهدافاً ترفيهية وثقافية مثل “تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان” و”تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة”.
ونجد من بين المؤشرات وصول ثلاثة مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة عالمية ملائمة للعيش في عام 2030، ووصول عدد مجموعات الهواة إلى 900 مجموعة. أما أهداف برنامج “تنمية القدرات البشرية”، فتشمل “تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية” مثل “قيم الوسطية والتسامح” و”الاتقان والانضباط”، و”تمكين حياة عامرة وصحية”، و”زيادة معدلات التوظيف” عبر تبني استراتيجية تعليمية مختلفة.
ولتجاوز حالة التشظي المؤسساتي وانعدام التنسيق الأفقي، مكّن كل برنامج لينسق العمل بين عدد من الوزارات والمؤسسات لضمان تحقيق أهدافه. فتحت برنامج “جودة الحياة” تندرج وزارات السياحة والثقافة والرياضة وهيئة الترفيه وغيرها، وتحت برنامج تنمية القدرات البشرية نجد وزارات التعليم والموارد البشرية والاقتصاد وغيرها.
ولا تتوفر معلومات حول ميزانية كل برنامج، لكن عندما أطلقت خطة جودة الحياة للفترة من 2018-2020 ذُكر أن ميزانيته 13.3 مليار دولار، وفي نشرة ميزانية 2023 ذكرت ميزانية البرنامج ضمن ميزانية قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية التي تضم غيره من المبادرات حيث قدرت بـ 50 مليار دولار (16.8 في المئة من إجمالي ميزانية 2023). أما برنامج تنمية القدرات البشرية، فلا توجد معلومات معلنة عن ميزانيته.
يمثل هذان البرنامجان السياق العام الذي تحدث فيه صفقات مثل صفقة التعاقد مع رونالدو أو غيره من النجوم العالميين، أو سعي المملكة لاستضافة أحداث رياضية أو ترفيهية ذات صدى عالمي، أو إلغاء وتعديل الكثير من القيود القانونية ذات الأثر الاجتماعي.
فكما هو معلوم، قامت الحكومة برفع القيود القانونية التي كانت تفرضها في العديد من المجالات: من القيود المفروضة على المرأة، وسياحة الأجانب، وفضاءات الترفيه من دور السينما ومشاريع المدن الترفيهية والحفلات الموسيقية وغيرها.
وفي مجال الهوية الوطنية، نجد المناهج السعودية تُعلّم الطلاب في فصل “المواطنة الاقتصادية والاجتماعية” بأن حقوق المواطنة تشمل حفظ الدين والأمن والتعليم والعدل والمساواة وجودة الحياة، أما واجباتها فتشمل الفخر بالوطن واتباع قوانينه وكذلك الصدق والأمانة والمشاركة المجتمعية والتميّز والإبداع والمحافظة على البيئة والممتلكات.
فالعقد الاجتماعي الذي يصاغ بين الدولة والمواطن يخفف من شأن الدين ويتجاهل الحقوق السياسية، لكنه يعلي ويضاعف من الشأن الاقتصادي والاجتماعي عبر مطالبة المواطن بالتحوّل من مواطن يعتمد على الرعاية الرعوية من الحكومة إلى منتج ومبدع وبمهارات تسمح له بالمنافسة في الأسواق العالمية.
تنفذ هذه البرامج، بلا رقابة شعبية، وهي غير مقيدة بحقوق مدنية وسياسية، ولا تسمح بمشاركة مؤسسية للمواطنين في صناعة القرار. وعلى ما يبدو، فإن النخبة البيروقراطية التي تدير هذه البرامج، وكثير منهم جاءوا من القطاع الخاص أو خريجوا برنامج الابتعاث من الذين درسوا في دول ديمقراطية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، لا ترى أن هذه السمات السلطوية للبرامج عبئاً عليها التخلص منها أو صرف الإنتباه عنها، بل عبارة عن مزايا تساعدها في تنفيذ أعمالها.
ومن غير الواضح مدى التواؤم والتنسيق بين هذه البرامج والأجهزة الأمنية التي في بعض الأحيان تظهر وكأنها تعمل ضد أهدافها وفي أحيان أخرى بانسجام وتناسق معها.
أياً يكن الأمر، فإن هذه البرامج، بأهدافها الطموحة وميزانياتها الضخمة وآثارها الاجتماعية الكبيرة، تتطلب تعاط أعمق لفهمها وتحليلها ومقارنتها بغيرها من التجارب- في الصين وسنغافورة ودبي- التي سبقتها لبناء مدن ومواطنين عالميين بطريقة سلطوية ونيوليبرالية.



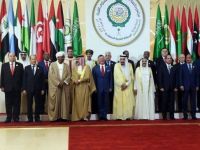
ارسال التعليق