 قالوا وقلنا
قالوا وقلنا
تطبيع #السعودية مع #الصهاينة: من الخفاء إلى العلن
بقلم: أسعد أبو خليل/ كاتب عربي…
أولويّة تحقيق التطبيع بين السعودية وإسرائيل تشغلُ الإدارة الأمريكية في سنة انتخابيّة. والموضوع لم يعد سرّاً من الأسرار، إذ إن المقايضة جارية في سوق المفاوضات الأميركية الإسرائيلية السعودية، بطرق مباشرة وغير مباشرة.
والتركيز المكثف على هذا الهدف لإدارة بايدن ينمّ عن جهل بسياسة وثقافة العالم العربي. يعتقد خبراء الشرق الأوسط في الإدارات الأميركية أن السعودية هي زعيمة العالم الإسلامي بحق وحقيق. لا يعلم هؤلاء أن السعودية، من دون الثروة النفطية، لا تزيد في النفوذ عن دولة موريتانيا أو لبنان. الحكم السعودي احتاج عبر عقود إلى التركيز على المشروعية الدينية الإسلامية للمملكة، خصوصاً بعد الثورة الإسلامية في إيران وبعد انتفاضة الحرمين في السعودية.
لم يعد المصدر التاريخي أو القبلي أو الجهادي أو النفطي كافياً لاستقاء المشروعيّة السياسية للدولة في منطقة كانت متفجّرة على الدوام. وفي الزمن الناصري كانت مشروعيّة النظام السعودي في الحضيض ولم يكن بمستطاع الحكم آنذاك إلا أن يستثمر في الصحافة اللبنانية الفاعلة، خصوصاً في صحيفتي «النهار» و«الحياة»، من أجل صدّ المد القومي الناصري الذي سلب عقول الملايين من العرب (كان ذلك يوم انشقّ أمراء من آل سعود للالتحاق بالمشروع الناصري—لم يرد الأمير طلال بن عبد العزيز أن نذكّره بانشقاقه).
وتصنّع الاهتمام بقضية فلسطين كان جزءاً من المشروعية السياسية الدينيّة للنظام السعودي. وكان الملك فيصل يختصر موضوع القضية الفلسطينية بقدرته على الصلاة في القدس كأن الصلاة بحدّ ذاتها تكفي لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني. وأنور السادات صلّى في القدس ولم يحقّق ذلك أي نصر أو فوز للشعب الفلسطيني لا بل كان ذلك من الأسباب المدمّرة لإطلاق يد إسرائيل في لبنان وفي فلسطين لتمعنَ فيهما خراباً ودماراً.
في عهد رونالد ريغن لم تعد الإدارة الأميركية تقبل حتى بالخطب العربيّة الرنانة عن الجهاد وعن تحقيق النصر في فلسطين. على العكس، بدأت الإدارة الأميركية منذ عهد ريتشارد نيكسون بالضغط على حكومة السعودية للضغط على حركة «فتح» (المرتهنة لها بشخص ياسر عرفات) من أجل صدّ مدّ اليسار الفلسطيني الثوري. أصبحت الولايات المتحدة، في زمن وليّ العهد فهد (والملك فهد) الذراع المعتمدة لتحقيق التنازلات العربية لإسرائيل. ونستطيع أن نقول إن صعود الملك فهد تزامن مع تقديم تنازلات عربية هائلة من قبل الجامعة العربية مجتمعةً. بدأ ذلك بمشروع فهد في عام 1981.
وتبلور ذلك في المشروع السعودي للسلام الذي احتاج من أجل تمريره في الجامعة العربية إلى رشوة دول عربية ومنظمة التحرير (لا يزال الرئيس المقاوِم إميل لحّود يمتلك أسرار تلك القمّة المشينة التي تواطأ فيها أركان في النظامين اللبناني والسوري ومنظمة التحرير). القضاء على منظمة التحرير في صيف 1982 فتح الطريق أمام السعودية لوراثة مبادرة السلام الساداتية. ومن المعلوم أن السعودية لم تقطع علاقاتها مع السادات حتى بعد زيارته للقدس، وكانت تومئ له بالموافقة سرّاً. لكن الاجتياح العراقي للكويت شكّل فرصة لكل دول الخليج للتملّص من أي التزام بالقضية الفلسطينية (ولم يكن الالتزام إلا لفظيّاً قبل ذلك) ومعاقبة منظمة التحرير ليس فقط على موقفها من الاجتياح العراقي للكويت بل على تاريخ طويل لها من القبول بنقد لأنظمة الخليج وسياساتها الممالئة لأميركا.
طبعاً، لم تكن حكومات الخليج معنيّة، أو تعتبر نفسها معنية بالقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية كانت بالنسبة إلى الحكام العرب عبئاً عليهم لأنها كانت تعني الكثير للشعوب العربية منذ ما قبل النكبة. كان الشعب العربي بجماهيره يضغط على الحكومات كافة من أجل حثّها على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله. هم الذين كانوا وراء قرارات شكليّة من قبل الحكومات العربية للمشاركة عبر جيوش مترهّلة في حرب فلسطين. وفي الخفاء، كانت كل الأنظمة العربية تتآمر ضد الشعب فلسطيني. والثورة المصرية والانقلاب على النظام الملكي كانا ينبعان، في ذهن عبد الناصر ورفاقه، من التقصير الهائل الذي حكم أداء الجيش المصري في حرب فلسطين. كان الهمّ الفلسطيني ضاغطاً في أذهان الثوار الأحرار، طبعاً هذا لا يسري على شخص أنور السادات (الذي كان في صالة سينما يوم إطلاق الثورة) الذي تكيّف مع كل مرحلة يتبع فيها جمال عبد الناصر ويوافق على كل ما يقول وعلى كل ما يفعل إلى أن أتت الفرصة كي يعبّر عن مكنوناته الحقيقية في انتهاج سياسات معاكسة لسياسات جمال عبد الناصر. الحكومات الخليجية كانت بعيدة عن مسرح الصراع، وباستثناء صور لأمراء من آل سعود وهم يتدرّبون تهريجيّاً على السلاح، فلم يكن هناك إلا مساهمات فردية في دعم الشعب الفلسطيني، وإذا قامت حكومة ما بدعم ما فإنها فعلت ذلك من أجل مشروعيّته السياسية.
إن القضية الفلسطينية، والتظاهر بدعمها، شكّلا عنصراً أساسياً في تشكيل المشروعية السياسية لكل الأنظمة العربية. ولهذا كانت تلك الأنظمة تتنافس في ما بينها في إظهار أو اصطناع الدعم لشعب فلسطين في معاركه وفي محنته.
فالنظام السعودي لم يبع أرض فلسطين، كما يروّج الكثير من العرب على مواقع التواصل ويستندون في ذلك إلى وثيقة مزوّرة باع فيها الملك عبد العزيز فلسطين للصهاينة. لم تكن ملكاً له كي يبيعها. وهناك دليل على أنه تم بحث القضيّة الفلسطينيّة في اللقاء الشهير للملك عبد العزيز وفرانكلن روزفلت. كان الموضوع ذا بعدٍ ديني عند الملك عبد العزيز، وعند غيره من الحكام العرب آنذاك، ولكن الولاء للمستعمر البريطاني، ثم الأميركي، تفوّق على الاهتمام بقضية فلسطين. والأهم من ذلك أن تلك الحكومات الخليجية كانت في صفّ الخندق الصهيوني على الصعيد العالمي. وهي أقامت خندقاً مضاداً للمعسكر الذي أقامه جمال عبد الناصر ورفاقه من أجل الترويج للوحدة العربية والحرص على فلسطين. حزب البعث في عقيدته ولّى القضية الفلسطينية اهتماماً لكنه ربطها أو ذيّلها لأولوية الحفاظ على النظام والقضاء على الخصوم وضرب المنافسين البعثيّين والمزايدة على جمال عبد الناصر في كل شيء.
لماذا هذا التركيز من جو بايدن على موضوع التطبيع مع السعودية؟ والكونغرس الأميركي يعتبر هذا الموضوع هدفاً يوحّد بين الخصوم الديموقراطيين والجمهوريّين. وقد سنَّ مشروعاً لتعيين سفير خاص يُعنى بما يسمى «اتفاقيات إبراهيم». دشّنت الحكومة الأميركية في أوائل السبعينيات ما بتنا نسمّيه بـ«مسيرة السلام»، وهي توقّفت. وفي كل هذه السنوات لم يكن تحقيق السلام لشعب فلسطين ذا أهمية. اليوم تنشّطت كل أجهزة وإدارات الدولة الأميركية لنشر التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الذي بات مثالاً يجب أن يُحتذى، وإن بالقوّة. جو بايدن هو الرئيس الأميركي الوحيد الذي عرّف عن نفسه بأنه صهيوني. لم يقلها رئيسٌ من قبل. هو خدع شباب الحزب الديموقراطي الليبرالي في حملته الانتخابية عندما تصنّع الحرص على حقوق الإنسان في العالم وعندما خفّض من منسوب خطابه الشديد الصهيونية تقليدياً.
ولا نزال نذكر أنه وصف محمد بن سلمان بتوصيفات شنيعة ووعدَ بأن يعامل السعودية كدولة مارقة. كل هذا كان كذبة من أجل أن يحصل على دعم الليبراليين في الحزب الديموقراطي الذين باتوا أكثر مناصرةً لشعب فلسطين من إسرائيل. وجو بايدن يفتقر، كما أوباما وكما كلينتون من قبل، إلى الودّ والنيّة على التعاون من قبل الحزب الجمهوري المتعنّت. لكن بايدن يعلم أن طرح أي مشروع يخدم إسرائيل سينال تلقائيّاً التأييد والحماس من كل عناصر الحزب الجمهوري ومن قياداته في الكونغرس الأميركي.
والحماس الأميركي على تحقيق السلام بين طغاة العرب وإسرائيل مبني على وهم مفاده أن مجرّد توقيع اتفاقيات سلام سينهي الصراع العربي الإسرائيلي. ما تفعله إدارة أوباما هو ما كان نتنياهو يطالب به لسنوات طويلة، بأن القضية الفلسطينية ستنتهي من تلقاء نفسها بمجرّد أن يوقّع حكام العرب على اتفاقيّات سلام مع إسرائيل، وأن السلام بين السعودية وإسرائيل من الأهمية بمكان أنه سينشر فكرة السلام وقبول إسرائيل في كل العالم العربي والإسلامي وهذه الفكرة تفتقر إلى المعرفة بالثقافة العربية السياسية والإسلامية كما تفتقر أيضاً إلى دراية بمزاج وأهواء الرأي العام العربي والإسلامي الذي لا يزال يعتبر القضية الفلسطينية قضيّة القضايا.
وإعلان التحالف بين دولة الإمارات وإسرائيل لم يؤثّر بتاتاً على قبول إسرائيل بين العرب. على العكس من ذلك، فإنه أثار الكثير من الاعتراض والامتعاض في أوساط العرب الأحرار لأن معظم العرب، خصوصاً في دول الخليج، مغلوبٌ على أمرهم ولا قدرة لهم على التعبير بحرية عن آرائهم التي تختلف عن آراء الطغمة الحاكمة. إنّ الكلام الذي يصدر عن إعلاميين عرب (خصوصاً من اللبنانيين الذين سخّروا كل طاقاتهم لعبادة الحكام وخدمة مصالحهم، هؤلاء الذين هتفوا للسعودية عندما شنت حملة على قطر وعادوا وهتفوا لها عندما تصالحت مع قطر. هؤلاء هم الذين هتفوا للسعودية والإمارات عندما حوّلوا إيران إلى أكبر عدو للعرب في تاريخهم، وهتفوا للسعوديّة عندما قرّرت، لأسباب خاصّة بها، التصالح الشكلي مع إيران) مدفوع أجره مسبقاً.
ماذا تستطيع أميركا أن تقدّم للسعودية وماذا تستطيع السعودية أن تقدّم لأميركا؟ تستطيع السعودية أن تقدّم لأميركا تطبيع دولة عربية بارزة وإيهام واشنطن أن ذلك سيغيّر من الثقافة السياسية العربية. لكن مصر هي الدولة العربية الكبرى وقد فرض حكامها منذ عام 1979 السلام المذلّ والمهين مع إسرائيل وكل ذلك لم يغيّر من هوية وهوى الشعب المصري. يكفي ما حدث أخيراً في قضية ما سمي على مواقع التواصل بـ«الجندي المصري»، الذي أطلق النار على جنود إسرائيليين. تحوّل في غضون ساعات فقط إلى بطل قومي.
السعودية تستطيع أن توهم أميركا بأنها ستقدّم لهم، أو ستقدّم لتل أبيب، العالم الإسلامي على طبق من ذهب كأن حكام السعودية هم زعماء مسلمون تاريخيّون، كما كان جمال عبد الناصر زعيماً عربياً وإسلامياً (وقد نشطت أجهزة الدعاية السعودية أخيراً بعقد مقارنة بين شخصية جمال عبد الناصر وشخصيّة محمد بن سلمان. وفي المقارنة بين الرجلين الملائمة كما بين المقارنة بين شخص نجيب ميقاتي وصلاح الدين الأيوبي).
قائمة المطالب السعودية لأميركا طويلة بالنسبة إلى ملف التطبيع. هي تطالب بحماية أمنيّة استراتيجية للنظام السعودي. هي تريد أن تتعامل أميركا مع السعودية كما تتعامل مع أعضاء حلف شمال الأطلسي، أي أن تعتبر أن أي اعتداء على أراضي المملكة هو اعتداء على الولايات المتحدة الأميركية.
وهذا سيترتّب عليه التزامات ونشر قوات ودعم وسيورّط الحكومة الأميركية في صراعات السعودية على مدى عقود طويلة. كما أن ذلك سيفرض على الحكومة الأميركية تقديم مساعدات عسكرية طبعاً (مقابل وفير من المال) بمستوى لم تقدّمه من قبل لدول عربيّة. كما أن السعودية، مثل الإمارات، تعتبر أن تحقيق السلام مع إسرائيل يجب أن يؤدي إلى رفع مستوى السلاح الذي تحصل عليه السعودية من أميركا. ومن المعروف أن أميركا تتقصّد بأن تعطي لإسرائيل من السلاح المتطوّر ما تحرمه على الدول العربية لالتزامها بوعد ضمان تفوّق إسرائيل العسكري على كل الدول العربية مجتمعة. كما أن السعودية ستطلب حماية رسمية واعترافاً ورعاية لتنصيب محمد بن سلمان ملكاً مدى الحياة.
وهذه الشروط ستورّط الحكومة الأميركية على مدى عقود طويلة في دفع أثمان جرائم ومغامرات السعودية في المنطقة، كما أنها ستجعل من أميركا مسؤولة عن كل ارتكابات حقوق الإنسان في داخل المملكة، وستحرمها من فرصة إصدار بيان، مرّة كل سنتين، عن اهتمامها العميق بحقوق الإنسان في المملكة. وستصبح أميركا عاجزة عن الاستمرار في نفاق الحرص على حقوق الإنسان في السعودية وفي العالم العربي. وتطالب السعودية أيضاً بدعم أميركا لإنشاء برنامج طاقة نووية خاص بالسعودية.
طبعاً، السعودية تستطيع أن تقدّم مقابل التطبيق ما يلائم المصلحة الإسرائيلية الكبرى في الاعتبار الأميركي. هي ستضطر إلى جعل مستوى التطبيع كما هو عليه في الإمارات، أي التحالف التام بين المملكة وإسرائيل. كما أنها ستلتزم بالضغط على كل الحكومات العربية والإسلامية لجرّها إلى عقد اتفاقيات سلام مع إسرائيل ولطي الخطاب الإسلامي والعربي التقليدي عن دعم قضية شعب فلسطين. كما أن السعودية ستلتزم بطي مشروع السلام السعودي واعتباره من مخلّفات التاريخ السحيق.
ويقول رجل أعمال لبناني خبير بالسعودية (التي عاش فيها وعمل لسنوات ويعرف شأن أمرائها) إن التصالح المفاجئ مع إيران لم يكن إلا مقدّمة لتحقيق التطبيع مع إسرائيل. لأن التصالح مع إيران سيمنع الحكومة الإيرانية من شنّ حملة ضد التطبيع السعودي خصوصاً من المنظور الإسلامي الذي يعني للدعاية السياسية السعودية الكثير (حتى في زمن ابن سلمان).
وهذا ما حدث تماماً في حالة الإمارات التي تصالحت مع النظام السوري وأدّى ذلك إلى منع أي اعتراض سوري على التحالف الصفيق بين حكام الإمارات وإسرائيل. ليست المصالحة مع إيران إلا من أجل أهداف تتعلّق بالمصلحة الأمنية والسياسية لصعود محمد بن سلمان.
محمد بن سلمان في كل ما يفعله هذه الأيام يمهّد طريقه للعرش ويريدُ لحكمه أن يستمر لعقود طويلة وبضمانات أميركية وإقليمية. والذي يتابع الصحافة السعوديّة بعد تحقيق هذه المصالحة يدرك كم أنها لم تغيّر قيد أنملة من الفرضيّات والعقائد السعودية ضد إيران. وحدها إيران تأخذ هذه المصالحة على محمل الجدّ وهي طبعاً تريد تبريد الأجواء من أجل تخفيف العقوبات عليها، كما أن السعودية تريد تبريد الأجواء من أجل وقف الحرب المذلّة لها في اليمن.
لكن هذه المقايضة التجارية بين أميركا والسعودية ذات فوائد محدودة للغاية للطرفيْن. إسرائيل ستكون المستفيد الأكبر لأن السعودية ستضمن لها حملة ديبلوماسية عالمية لتحسين صورتها ولتسويغ إقامة علاقات معها مقابل لا شيء بالنسبة إلى الملف الفلسطيني. إنّ هذا الحماس الأميركي لتطبيع إسرائيل مع السعودية يهدف إلى القضاء التام على المطالب الوطنيّة الفلسطينية. سيتضمن الاتفاق بين إسرائيل والسعودية وعوداً عامة مبهمة عن الشعب الفلسطيني من دون تقديم أي تنازل، لا في القدس ولا في الدولة الفلسطينية ولا في حق العودة ولا في أمن الشعب الفلسطيني. على العكس، فإن الاتفاق سيترافق مع إعلان عام من الطرفين عن دولة فلسطينية تتحقق في ظل الاحتلال الإسرائيلي ومن ضمن تقطيع أوصال الضفة والغزة ومن ضمن سيطرة إسرائيل على الأرض والجو وثروات الضفة والقطاع.
والتطبيع بين إسرائيل والسعودية جار منذ عام 2000، والأمير بندر هو الذي دشّن هذه العلاقة. طبعاً كانت هناك اتصالات وعلاقات وتنسيق بين إسرائيل والحكم السعودي منذ الستينيّات، خصوصاً في التعاون في حرب اليمن ضد عبد الناصر والمشروع القومي العربي. وفي تقرير جديد لمنظمة «إمباكت» التي ترصد من لندن ما يُسمّى بنزعات التسامح في المناهج الدراسية في السعودية لاحظوا أن السعودية، من دون أي إعلان ومجاهرة، باشرت بتعديل المناهج الدراسيّة وقلبها رأساً على عقب، كما فعلت كل الأنظمة الخليجية من أجل إرضاء اللوبي الإسرائيلي (قطر أوكلت إلى مؤسّسة «راند» تعديل مناهجها). كل الإشارات السلبيّة إلى اليهودية والمسيحية والمسيحيين واليهود أزيلت وهذا جانب حسنٌ لأن المنهج الدراسي السعودي كان مليئاً بإشارات الكراهية ضد الأديان والمذاهب الأخرى.
طبعاً، الإشارات ضد الشيعة وأقليات أخرى لا تزعج أحداً في الغرب ولا تزعج ضمائر هؤلاء الذين يرصدون المناهج: ما يعنيهم هو تهيئة مناخ ملائم للتطبيع مع إسرائيل. وفي الموضوع الفلسطيني تمّ تعديل الكثير من الإشارات، فقد أزيل تعبير «العدو الإسرائيلي» أو «العدو الصهيوني» وتم استبدال هذه المصطلحات بتعبير «الاحتلال الإسرائيلي» أو «جيش الاحتلال الإسرائيلي». وفي المنهج الجديد، في درس عن الشعر الوطني، تمت إزالة مثال عن معارضة الاستيطان اليهودي في فلسطين. وفي منهج دراسة المرحلة الثانوية تمت إزالة الإشارة إلى الانتفاضة الفلسطينية في الثمانينيّات.
وفي كتاب مدرسي آخر تمّت إزالة فصل كامل عن القضية الفلسطينية. المنظمة الغربية قالت إن هذه إشارات إيجابية، تعني أن هناك تقدّماً في المواقف من إسرائيل والصهيونية.
محمد بن سلمان سيصعد إلى العرش. لن يقف في طريقه شيء. الأثمان لا تعني له شيئاً ودول الغرب تريد أن تستولي على المال النفطي من دون وازع. لن تقف في طريقه معارضة أو دول أو مبادئ. دول الغرب الديموقراطية المعنى ستفرش دربه بالورود والرياحين، وستتولّى إسرائيل ترتيب حفل التنصيب.

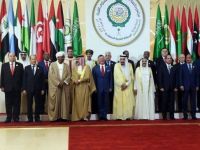


ارسال التعليق