 قالوا وقلنا
قالوا وقلنا
مستقبل العلاقات الأميركية "السعودية" بين الثابت والمتغير
بقلم: يارا بليبل...
مع وصول جو بايدن إلى سدّة الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية، انتهجت الإدارة الجديدة سياسة مغايرة لإدارة ترامب تجاه "السعودية"، مع الاخذ بالاعتبار غلبة رؤية "الاتجاه التقدمي" في الحزب الديمقراطي والأخذ بتوجهاته والذي يزعم مناصرته لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان وتعزيز العمل بها، تخفيض الوجود العسكري في المنطقة، ويدعو إلى العودة للإتفاق النووي مع إيران وإلى إعادة ضبط العلاقات الأمريكية مع دول "الخليج" بما يخدم مصالحها و"قيمها".
وفي السياق عينه، تم رفع اسم جماعة الحوثي من قائمة الجماعات الراعية للإرهاب والادعاء بتعليق صفقات أسلحة لكلا من الرياض وأبو ظبي تستخدم في الحرب في اليمن والدعوة لتفعيل المساءلة عن انتهاكات حقوق الانسان في "المملكة" مقابل الاستمرار في علاقات الاعمال. الأمر الذي أظهر توترا في العلاقات الامريكية "السعودية" وتخليا عن دعم الولايات المتحدة للتحالف الذى تقوده "السعودية" في اليمن ضد الشعب اليمني.
لا بدّ من التأكيد أولاً على أن علوّ سقف التجاذبات السياسي بين الطرفين لا يلغي، بأي حال من الأحوال، حقيقة حاجة كلا الطرفين لبعضهما البعض. فإن الموقع الجيوسياسي المهم "للخليج" بشكل عام و"المملكة" بشكل خاص، كنقطة التقاء بين شرق آسيا وأوروبا، واحتياطات النفط الأكبر عالميا في هذه المنطقة. إضافة إلى وجود الكيان الصهيوني كذراع عسكرية غربية لضبط الطموحات السياسية للقوى الفاعلة، سواء كانت كيانات سياسية مقاومة أودول أو حتى شخصيات قيادية، في مناهضة الهيمنة الغربية، والتحرر والاستقلال الوطني، والبيئة الإقليمية السياسية والثقافية والأمنية والاقتصادية التي تبنيها. كل ذلك يجعل من "السعودية" ظهيراً مالياً وسياسياً ونفطياً هاماً للكيان الصهيوني من خلال لعب أدوار متنوعة تستهدف حمايته من المدّ التحرري المتمثل بمحور المقاومة.
محددات العلاقة بين واشنطن والرياض:
ظهرت مع بداية عام 2011، الخلافات الأمريكية – "السعودية" على السطح نتيجة اختلاف قراءة الطرفين للأحداث والتغيرات الإقليمية المتلاحقة ومن أبرز هذه القضايا الإقليمية موجات الحراك الاحتجاجي الشعبي والتي عرفت بـ “ثورات الربيع العربي” منذ نهاية عام 2010، وبداية عام 2011 والتي ولّدت مجموعة من التحديات كان على دول المنطقة مواجهتها وإيجاد مقاربات على مستوى سياستها الخارجية من أجل التعامل معها، وكان النظام السعودي في مقدمتها بحكم أن تداعياتها أصبحت تنعكس على أمنها القومي والاستقرار الإقليمي. من ناحية أخرى، أثرت هذه التحولات الجيوسياسية على العلاقات الأمريكية – "السعودية" وتعاملهما مع التغيرات الإقليمية في كل من (البحرين واليمن ومصر وسوريا)، ففي بعض الملفات تقاطعت المصالح وفي بعض الملفات الأخرى حدث تصادم، كما كان للتقارب الأمريكي مع إيران في عهد الرئيس أوباما والتي تم في إطاره التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي ورفع العقوبات الاقتصادية عنها، وتوقيع اتفاق جنيف المرحلي بشأن الملف النووي الإيراني في يوليو 2015 تأثيراً على تزايد حدة التوتر في العلاقات الأمريكية "السعودية" وإثارة المخاوف بشان الحماية الأمنية للخليج في مواجهة ايران . لقد تبنت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما سياسة الانكفاء الأمريكي عن الشرق الأوسط و العمل علي الحد من التدخل الأمريكي وتراجع الاهتمام والتوجه نحو آسيا سواء للمشاركة في ثمار النمو لهذه القارة الواعدة اقتصادياً، أو لمواجهة تصاعد النفوذ الاستراتيجي الصيني بها، والذي تجد فيه خطرا واشنطن خطرا على مصالحها وهيمنتها.
وبالاستناد إلى ما سلف، تمايز بايدن عن ترامب في رؤيته لمنطقة الشرق الأوسط والأولويات التي رسمها لتوجهاته. إذ يمكن القول أن بعض الملفات الطارئة حالت دون المضي في نهج الإدارة الأميركية وفرضت على سيد البيت الأبيض إعادة تدوير الزوايا من بوابة الاستحقاقات الحالية والمرتقبة في الداخل الأميركي.
وفي هذا المضمار لا بدّ من الإشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا وانعكاساتها على سوق الطاقة، والتي سمحت بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء رغما عن الرغبة الأميركية. حيث أثر ارتفاع أسعار المحروقات والتعنّت "السعودي" رفضا لمجاراة البيت الأبيض ورفع مستوى الإنتاج في الفترة الأولى في زيادة منسوب الضغط على الداخل الأوروبي والأميركي في آن، لناحية زيادة مفاعيل التضخم وما تلاها من نقمة شعبية مؤثرة على شعبية بايدن، الذي يسعى وحزبه للحفاظ على الأغلبية الهشة في الكونغرس في الانتخابات النصفية المرتقبة.
زمن الوئام قد ولّى:
وبالانطلاق مما ورد، يمكن الحديث عن بعض المتغيّرات التي باتت تحكم شكل العلاقات بين الرياض وواشنطن:
أولاً، إن شكل العلاقات القائمة على النفط مقابل ضمان أمن النظام منذ لقاء عبد العزيز آل سعود بالرئيس روزفلت عام 1945 والتي تُعرف باسم "اتفاق كوينسي"، قد شاخت وتراجعت أهميتها بعد اكتفاء الولايات المتحدة ذاتيا من مصادر الطاقة على أراضيها، رغم اهتمام الأميركي بأسواق وأسهار النفط بعد الحرب الأوكرانية بشكل متزايد، والدور "السعودي" في هذا المجال.
ثانياً، حالة الازدراء الشعبي التي اكتسبها بن سلمان، سيّما مع ضلوعه في عملية قتل الصحافي وكاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، جمال خاشقجي. والتي تضاف للصورة الذهنية السيئة "للمملكة" منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2000، وكل ما سُجّل من انتهاكات وقمع للتحركات الشعبية في شبه الجزيرة العربية وعمليات الإعدام التي ما فتئت تتوالى بحق معتقلي الرأي، ولوّ أن الأخيرة لم تحظ بالضوء المطلوب لتبيانها إعلاميا، ساهمت جميعها في توهين صورة بن سلمان بشكل نسبي بين فئات المجتمع الأميركي.
ثالثاً، يبدو ابن سلمان أكثر ميلاً إلى ضمان استمرار نظام الحكم في "المملكة" عبر الاعتماد على تعدد نفوذ الأقطاب الدوليين في المنطقة، بما يضر مصالح الولايات المتحدة، في الوقت الذي تحوّل فيها واشنطن جهودها باتجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة الصعود الصيني. وقد ظهر ذلك في تقارب الموقف الصيني و"السعودي" من الحرب على أوكرانيا والاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي بلغت قيمتها 65 مليار دولار، إلى جانب التعاون العسكري المسجل لناحية زيادة منسوب الصواريخ الصينية وتطوير برنامج الرياض للصواريخ البالستية بمساعدة بكين.




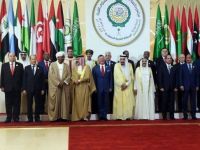
ارسال التعليق