 قالوا وقلنا
قالوا وقلنا
محو #الأحساء و #القطيف من الخريطة: المشروع #السعودي المؤجل
بقلم: حمزة الشاخوري...
منذ عقود بعيدة، وتحديداً في عام 1913 حين بسط عبد العزيز بن سعود سيطرته على الأحساء، وتالياً على القطيف، وانتشار مقاتليه المؤدلجين كجنود احتلال في أعقاب طرد الحامية العثمانية وهزيمة المقاومة الشعبية المحلية إثر تخاذل وتقاعس وخيانات الإقطاع المحلي وشبكة المتنفّذين في المنطقة... منذ ذاك الوقت المبكر، وربما قبل ذلك إبّان العهد السعودي الأول في القرن الثامن عشر، اكتشف السعوديون أن إقليم الأحساء والقطيف ينطوي على عناصر رفض وتمرد ومقاومة للاحتلال تحت أي عنوان ومسمّى ولافتة!
فالوهابية التي شكّلت رافعة لبسط نفوذ الاحتلال السعودي على مناطق شبه الجزيرة العربية بذريعة التطهر الديني ونشر الإسلام، تتناقض كلياً مع عقيدة السكان الأصليين في إقليم الأحساء والقطيف، الذي عُرف في حقب تاريخية متقدمة بـ«إقليم البحرين». تناقضٌ أدّى على الدوام إلى فشل السلطة في استتباع وإخضاع أهالي المنطقة كنتيجة طبيعية لسياسات التكفير والإقصاء والحرمان والتهميش والنبذ من كل ما له صلة بمراكز ومؤسسات صنع القرار الاستراتيجي لإدارة شؤون البلاد.
في المقابل، أدرك السعوديون الأوائل أن إقامة مملكتهم ومشروع حكمهم لا يمكن أن ينجح ويتوطد دون احتلال إقليم الأحساء الغني بثرواته الاقتصادية والزراعية وموقعه الجيوستراتيجي وما يؤمنه من اتصال برّي وبحري مع دول الجوار والعالم، ومن دونه تصبح نجد والرياض مجرد هِجَر أو قرى استيطانية معزولة وسط الصحراء.
وسرعان ما تأكدت، وتعاظمت، أهمية إقليم الأحساء بعد اكتشاف الثروة النفطية في المنطقة نفسها التي أنعم الله عليها بغنى الطبيعة، ظاهرة وباطنة، براً وبحراً. فكان الإقليم ولا يزال مصدر وشريان خزينة العرش السعودي وميزانيته في نسختَيه البائدتين والحالية. وطوال عقود الحكم السعودي الراهن، شهد الإقليم ولادة ثورات وانتفاضات شعبية متتالية، كما احتضن تبرعم عشرات الأحزاب والحركات والجماعات المعارضة للنظام السعودي من مختلف المرجعيات والأيديولوجيات اليسارية والقومية والبعثية والشيوعية والإسلامية، بدأت بحركة الاعتراض للزعيم السياسي عبد الحسين بن جمعة (1914)، مروراً بثورة الإمام الشيخ محمد بن نمر (1929)، وحركة الإضرابات العمالية (1945) و(1953) و(1956)، وذروة النضال اليساري في السبعينيات، ثم انتفاضة المحرم (1979)، وليس انتهاء بانتفاضة الكرامة (2011) التي قادها الشهيد الشيخ نمر النمر (2016).
وطوال هذه السنوات، مارس السعوديون بحق الثوار والمعارضين أبشع صنوف القمع والسجن والتعذيب والقتل والتصفية والاختطاف والاغتيالات الميدانية ومجازر الإعدامات الجماعية والفردية. وفي الأحساء تحديداً، بقروا بطون الحوامل ورموا الرجال من فوق أسطح المباني وذبحوا الشيوخ وسط الأسواق، في أجلى تمظهرات الداعشية الوهابية. وبرغم ذلك كلّه، فشلوا في إركاع الشعب وكسر إرادته في رفض احتلالهم وهيمنتهم وسلطتهم الديكتاتورية. ومع تعاظم فشلهم في وأد انتفاضة الكرامة، كشفوا ما كان مخفيّاً وأظهروا من أدراج أحقادهم التاريخية مخططاتهم المؤجلة، فراح كتّاب صحفهم و«ذبابهم الإلكتروني» يدعون صراحة وبكل صفاقة إلى «مسح العوامية ومساواتها بالأرض لتكون عبرة للبقية»! فيما دعا آخرون، بنفَس طائفي بغيض، إلى تنفيذ سياسة «ترانسفير» لعموم الشيعة في المنطقة، أي لنحو 95% من سكانها الأصليين!
لا يزال أصحاب تلك الدعوات التي احتضنها الإعلام الرسمي السعودي يسرحون ويمرحون بلا حساب وبلا عقاب، ما يؤكد أنها ليست سبق لسان ولا اجتهاداً لحظيّاً أملته حراجة الظرف وسخونته ومأزق السلطة أمام تصاعد الغضب الشعبي واستمرار التظاهرات الجماهيرية واستقطابها زهاء 100 ألف مشارك في تشييع جثامين الثوار المضرّجين بدمائهم تحت جنازير المدرعات السعودية ورصاص مجنّديها وقذائفهم. بل كانت لحظة إعلان الساعة الصفر للبدء بتنفيذ الخطة المؤجلة والرغبة المكبوتة منذ عقود في تنفيذ «التطهير الطائفي» والوصول إلى «أرض بلا شعب» واقتلاع السكان «المشاكسين» لكي يتمتع «السعونجدي» بكامل الأرض وما تحتها وما عليها من ثروات وإمكانات!
تنبغي الإشارة هنا إلى أن السلطات السعودية نفذت منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي عملية تغيير ديموغرافي واسعة نجحت إلى حد كبير في «استبدال» طبيعة التركيبة السكانية التاريخية للمنطقة، عبر استنبات أو توسعة مدن حديثة كالظهران والخبر والدمام ورأس تنورة والجبيل وعشرات المشاريع الإسكانية، حيث تم استجلاب مئات الآلاف من خارج المنطقة ليستوطنوها، سواء كانوا موظفين في القطاعات الحكومية التي حُرم السكان المحليون منها، أو تجاراً نجديين جاؤوا ليديروا شركات الأمراء وعقاراتهم ومشاريعهم التجارية المختلفة. وإلى جانب ذلك، كانت محاصرة التمدد العمراني للسكان الأصليين تجري، سواء أفقياً أو عمودياً، بعشرات الحجج والذرائع المفتعلة؛ فحتى وقت قريب، كان ممنوع على الشيعة في القطيف تشييد أي بناء من 3 طوابق! كما منعوا من تعمير المساحات البيضاء غير المأهولة بحجة تخصيصها لمشروعات «أرامكو». وبالتزامن مع ذلك، تم خلال مطلع الألفية الثالثة التلاعب بالحدود الإدارية للمدن الواقعة في الإقليم عبر تحجيم مساحات محافظة القطيف لمصلحة المدن المستنبتة التي سكنها الوافدون من نجد والجنوب، وحين تحرك أهالي المنطقة عبر لجان محلية، كـ«قطيف الغد» و«صمود من أجل الحدود»، جرى استدعاؤهم وإيقاف أنشطتهم تحت طائلة التهديد بالسجن!
فمخطط «السعونجديين» لتهجير الشيعة من مناطقهم إلى الشتات ليس جديداً، ولقد أرادوا من «غزوة العوامية» حسب ما سمّاها جحافلهم في منابر الإعلام الرسمي أن تكون «بروفة» ونموذجاً لما يُراد تنفيذه على كامل أرض الإقليم بضفّتيه، أي الأحساء والقطيف. بل أزعم أن اختيارهم مسمّى «المحافظة البيضاء» إلى المساحة المقتطعة من القطيف ليس بريئاً ولا عفوياً، بل ينطوي على دلالات رغبوية صارخة لإخلاء المنطقة من أهلها لتصبح فعلاً وواقعاً «بيضاء» أي أرض خلاء جرداء بلا سكان وبلا أبنية! أو الزعم مستقبلاً بأنها كانت كذلك، في تماهٍ متطابق مع المخطط الصهيوني الذي ارتكبه الصهاينة المؤسسون لكيان الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وينبغي أن نتنبه إلى أن النتائج التي ستتمخض عن تنفيذ المخطط السعودي في إقليم الأحساء ليست كما هي نتائج التجريف والهدم اللذين تعرضت لهما مدينة جدة أو تبوك أو المدينة المنوّرة، فتماثل الفعل/ الجريمة لا يعني تطابق الهدف بعيداً عن حجم الفعل/ الجريمة وسعة مداها الجغرافي. فما تعرضت له مناطق الحجاز هدفه الأساس إمرار مشروعات ابن سلمان البهلوانية والمزعومة، وهذا لا ينفي أو يقلّل من حجم الكارثة الإنسانية التي تعرّض لها سكان تلك المنطقة وجلّهم من الفقراء المسحوقين. لكن الهدف من التهجير في القطيف والأحساء استراتيجي بعيد الغور سينتج منه اقتلاع السكان من أرضهم ومحو معالم المنطقة واختفاء مدن وبلدات من الخريطة، وقد مهّد النظام السعودي لذلك بتغيير أسماء عشرات المدن والبلدات والشوارع في المنطقة.
المساحات التي أتت عليها جرافات آل سعود وهدمتها على رؤوس ساكنيها، وتلك المُدرجة على قائمة الهدم في قرارات وزارات الشؤون البلدية والنقل والطاقة شملت مئات البلدات والقرى والمدن والأرياف والمزارع والبساتين، ولم توفر شيئاً يذكر من مساحات القطيف المختنقة سكانياً بسبب الحصار المفروض على التمدد العمراني فيها منذ عقود، كما سبقت الإشارة. فلا بدائل أمام السكان المقتلعين من منازلهم سوى التيه في فيافي «مملكة آل سعود» وصحاريها بحثاً عن قطعة أرض أو مسكن إن استطاعوا تأمين ثمنه! وهو ما يعني خلخلة البنى الاجتماعية ونسف الروابط الإنسانية الحميمة مع الأرض والمسكن والبيئة المجتمعية بكل ما تعنيه من حمولات الذاكرة الجمعية والتاريخ المشترك وصور الذكريات الفردية. وهي الخطوة التي لا نستبعد تنفيذها في الأحساء في سياق الذرائع والمبررات ذاتها، أي إزالة بيوت آيلة إلى السقوط وأنسنة المدن وشق الطرق وتطوير حقول النفط والغاز!
إنّ الآلية التي تتبعها السلطة السعودية في تنفيذ مخطط الهدم والتهجير بالوتيرة المتسارعة والمتزامنة في مختلف مدن وبلدات المنطقة تفضح الغايات والأهداف المشبوهة من ورائه، فهي لم تكلف نفسها عناء تهيئة مخططات سكنية تتوافر على الخدمات الأولية وقابلة للإعمار والسكن، فضلاً عن عدم تشييدها مجمعات سكنية كبديل من آلاف البيوت والمنازل التي هدمتها، وتلك التي يجري هدمها أو ستهدم في قابل الأيام والشهور، في ترجمة فعلية لسياسة بعثرة المجتمع المحلي وتشتيته وعدم منحه فرصة إعادة التكتل في «بؤر» مجتمعية متقاربة تحفظ جذوره التكوينية وروابطه ومصالحه المشتركة وتضمن استمرار وبقاء بناه الاجتماعية وهويته الثقافية والتاريخية.
هذه السياسة السعودية لا تبدو نافرة، بل تأتي في سياقها الطبيعي. فالسلطة «السعونجدية» أجنبية عن الشعب ولا تنتمي إليه لا جغرافياً ولا تاريخياً ولا عقائدياً، وبالتالي هي تخطط وتعمل كسلطة احتلال، وإن مارست التهجير في يومنا هذا داخلياً ضمن نطاق سيطرتها الجغرافية فقد مارسته وألجأت إليه السكان في مراحل تاريخية مختلفة حين اضطرّ أهالي القطيف والأحساء إلى الفرار من البطش السعودي إلى بلدان الخليج، ولا سيما البحرين وقطر والكويت وكذلك العراق وإيران. وفي جميع هذه الدول، توجد حتى اليوم عوائل قطيفية وأحسائية، بل في بعضها هناك كتل بشرية كبيرة، كما في البصرة بالعراق والمحمّرة في إيران.

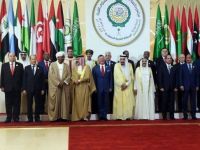



ارسال التعليق