 قالوا وقلنا
قالوا وقلنا
السلام العربي - العبري.. كيف زرعت واشنطن بذور التطبيع
بقلم: هبة بعيرات...
نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين شهدت العلاقات العربية-الإسرائيلية الرسمية اختلافات كبيرة، حيث تحولت من دول معادية للمشروع الصهيوني إلى أنظمة مطبعة بالعلن، تستقبل الوفود الإسرائيلية وترفع علم الكيان عاليًا فوق مرافقها، إلا أن هذا التحول لم يكن مفاجئًا أو وليد اللحظة، بقدر ما كان كاشفًا للمستور بعد عقود من التعاون السري بين الحكومات العربية و”إسرائيل”.
يطرح هذا المقال ضمن ملف “دبلوماسية الحبلين” تساؤلات عن دور الإدارات الأمريكية المتعاقبة في تطويع الحكومات العربية وجرها نحو التطبيع، وأثر السياسات الحزبية الأمريكية (الجمهورية والديمقراطية) على هذا الملف، وكذلك كيف تساوقت بعض الحكومات مع المشروع الصهيوني متجاوزةً مصالح شعوبها، وذلك منذ بداية تسعينيات القرن الماضي حتى يومنا الحالي.
كلينتون.. عصافير متعددة وحجر واحد:
اتفاقية وادي عربة، الموقعة في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994، لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت نتيجة لمسار طويل من التفاهمات السرية بين الملك حسين بن عبد الله والإسرائيليين على مدار عقود، على عكس ما كان يُشاع آنذاك بأن اتفاقية أوسلو دافعًا رئيسيًا وراء انجرار الأردن لتوقيع اتفاقية السلام وإسناد الفضل إلى الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون، فمنذ توليه العرش في الخمسينيات، كان الملك الأردني مهتمًا بتأمين حدود الأردن من الفدائيين الفلسطينيين قبل العصابات الصهيونية.
كانت لندن في البداية هي الراعية للتطبيع، لا واشنطن، حيث شهدت عاصمة المملكة المتحدة العديد من اللقاءات السرية بين الملك والمسؤولين الإسرائيليين، خاصة بعد حرب 1967، ومع ذلك لم تكن أمريكا غائبة عن تلك اللقاءات، فغالبًا ما كانت المخابرات المركزية وعدد من المبعوثين الأمريكيين الخاصين حاضرين أو يؤدون أدوارًا لتسهيل تلك اللقاءات.
الرئيس بيل كلينتون يتناول الغداء مع الملك حسين من الأردن، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من “إسرائيل”، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في مكتبة البيت الأبيض، في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1996
إذ لم تغفل الإدارات الأمريكية المتعاقبة عن مركزية الأردن في الشرق الاوسط وأهميته في حفظ أمن “إسرائيل”، فظلت تمد له حبل السلام كلما لاحت فرصة لذلك، بدايةً من اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 في ظل إدارة جيمي كارتر، مرورًا بلقاء شمعون بيريس عام 1985، وصولًا إلى الاتفاق السري عام 1987 في ظل إدارة رونالد ريجين، بقيت الولايات المتحدة متربصة بفرصة حقيقية لإطلاق قطار التطبيع في الشرق الأوسط بعد أن فشل الرئيس المصري أنور السادات بذلك.
استطاعت إدارة كلينتون اقتناص فرصة تاريخية فرضتها الظروف الجيوسياسية حينها، فقد أحكمت الخناق حول رقبة المملكة بالمساعدات الاقتصادية والديون التي بلغت 700 مليون دولار أمريكي بعد سنوات من التوترات الناتجة عن موقف الأردن من حرب الخليج وانحيازه لنظام صدام حسين، وما تمخض عن ذلك من قطع العلاقات الدبلوماسية وتعليق للمساعدات الاقتصادية.
كما ربطت واشنطن موافقتها على تسليح الأردن، بما في ذلك الطائرات المقاتلة F-16، بضرورة التوصل إلى اتفاق سلام مع “إسرائيل”، كما ألمح كلينتون للملك، فلم يكن أمام المملكة الأردنية إلا أن توافق من أجل استئناف الشحنات التي أقر الكونغرس بتعليقها، ولا بد من الإشارة هنا إلى الضغوط التي أثرت على القرار الأردني في ظل الاستقطاب وسباق التسلح المتسارع في المنطقة، ما دفعه إلى الخضوع للتطبيع.
بناءً على ذلك، ما كان لواشنطن أن تتخلى عن الأردن نظرًا لموقعه الحيوي من الكيان، وظلّ العم سام عرّابًا حقيقيًا لعملية التطبيع الهادئة والممتدة بين المملكة و”إسرائيل” حتى قطفت إدارة كلينتون ثمرة جهود العقود الماضية في “وادي عربة”.
قادت إدارة كلينتون جهودًا مماثلة مع سوريا ولبنان، فوفقًا لأرشيف البيت الأبيض أجرى كلينتون خلال فترتي رئاسته أكثر من 175 اتصالًا مباشرًا مع قادة المنطقة ومنظمات في الشرق الأوسط، وفتح المجال للقاءات سرية وأخرى علنية في البيت الأبيض بين مسؤولين إسرائيليين وزعماء عرب، وأطلق خلال تلك الفترة مبادرات كبرى لدفع عمليات السلام ما زال أثرها قائمًا حتى اللحظة في المنطقة.
نهايات فترته الرئاسية، حاول الرئيس الأمريكي بيل كلينتون تعزيز إرثه الدبلوماسي بجمع وزير خارجية سوريا، فاروق الشرع، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود باراك، في شيبردستاون (1999-2000) بهدف تحقيق اختراق في العلاقات السورية-الإسرائيلية.
لم تكن هذه أولى محاولات كلينتون لتطويع سوريا، إذ كانت محادثات السلام بين نظام حافظ الأسد و”إسرائيل” حتى عام 1996، تجري بإشراف أمريكي مباشر، حيث تخللتها زيارات مباشرة لوزير خارجية كلينتون، وارن كرسيتوفر، لدمشق، وتوقفت لاحقًا بسبب خلافات حول مرتفعات الجولان والأراضي السورية المحتلة التي رفضت “إسرائيل” التخلي عنها مقابل توقيع اتفاقية سلام بين الجهتين.
إلا أن السبب المباشر وراء فشل المحادثات السورية الإسرائيلية حينها كان تردد إدارة كلينتون بطرح مزيد من الحوافز المشجعة للأسد على اتخاذ الخطوة الدراماتيكية على خطى الملك الحسين، خاصة في ظل معارضة أمريكية داخلية قادتها منظمات يمينية وصهيونية وتصدرها الكونغرس بأكثرية الجمهوريين حينها، والتي كانت تعارض أي تنازلات إسرائيلية حقيقية للأسد، وتعتبر سوريا “دولة راعية للإرهاب” على عكس الأردن ومصر حينها.
ورغم الاستماتة الأمريكية على توقيع اتفاقية سلام مماثلة لتلك التي جمعت “إسرائيل” بالأردن، وإعدادها مقترحًا تحاول فيه إيجاد تسوية وسطية في المسائل الخلافية بين الطرفين، فإن كلينتون لم يفلح في مساعيه وأغلق دورته الرئاسية دون إنجازٍ آخر يضاف لمسيرته الطويلة في تطويع المنطقة.
فيما يخص لبنان، كانت إدارة كلينتون أكثر تركيزًا على الميليشيات المسلحة بدلًا من النظام الرسمي، خاصة بما يعزز نفوذها أو يضعف خصومها، فقد أشرفت الإدارة على تفاهمات “عناقيد الغضب” الموقعة في 26 أبريل/نيسان 1996 بين “إسرائيل” و”حزب الله”، والتي تضمنت التزام الطرفين بعدم استهداف المدنيين والقرى المأهولة، لكنها لم تصل إلى مستوى تحقيق التزام دائم بالسلام بينهما. تعكس هذه التفاهمات نهجًا براغماتيًا من الإدارة الأمريكية، حيث فضّلت إدارة النزاع على تسويته في ظل تعقيدات الساحة اللبنانية.
في المقابل، تعاملت إدارة كلينتون مع لبنان كامتداد للنفوذ السوري بسبب الوجود العسكري المكثف لسوريا وتأثير نظام الأسد على السياسة اللبنانية الداخلية، وهذا الواقع جعل الإدارة تعتبر أي انفتاح تفاوضي رسمي مع لبنان مرتبطًا بالتقدم في المحادثات السورية-الإسرائيلية، ومع توقف تلك المحادثات ووصولها إلى طريق مسدود، امتنعت الإدارة الأمريكية عن فتح قناة تفاوض مستقلة مع الحكومة اللبنانية.
مع ذلك، انضوى لبنان جزئيًا في جهود التطبيع التي قادها كلينتون من خلال مشاركته في “المجموعة التوجيهية متعددة الأطراف” المنبثقة عن مؤتمر مدريد 1991، والتي جمعت العرب بـ”إسرائيل” تحت إشراف أمريكي-روسي، وركزت على قضايا مثل الحدود واللاجئين والموارد الطبيعية، لكن مع اغتيال إسحاق رابين وصعود نتنياهو، تعثرت الجهود في 1995، ثم أحيتها وزيرة الخارجية، مادلين أولبرايت، ووزير الخارجية الروسي، إيغور إيفانوف، عام 2000، إلا أن الانتفاضة الفلسطينية الثانية وجهت ضربة قاصمة للمجموعة، ما أدى إلى توقفها قبل تحقيق أي نتائج ملموسة.
كما أسست إدارة كلينتون لضم أكبر وأهم قوة عربية لقطار التطبيع، السعودية، بشكل غير مباشر عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية الإقليمية، وإن قاومت المملكة حينها الانخراط العلني في مسار السلام وأبقت مباركتها لأوسلو واتفاقية “وادي عربة” ومن قبلهما مؤتمر مدريد في الظل.
غير أن إدارة كلينتون بمكرها المعروف مهدت لتطويع المملكة من خلال توثيق العلاقات الاقتصادية التي كانت “إسرائيل” طرفًا فيها، والذي أسست له قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاقتصادية بين 1994 و1997 وشجّع فيها كلينتون الحضور السعودي من جهة، وتعزيز النفوذ السعودي في أروقة السلطة الفلسطينية الوليدة من خلال التمويل المباشر وغير المباشر بواسطة جامعة الدول العربية من جهة أخرى.
إدارة كلينتون استغلّت أيضًا التوتر السعودي-الإيراني مبكرًا، مع تضخيم “خطر الجماعات الإسلامية المتطرفة”، خاصة تلك المرتبطة بإيران، لدفع المملكة نحو تحالفات تضم أمريكا و”إسرائيل” بشكل غير مباشر، ورغم أن هذه الجهود بقيت حبيسة وراء السواتر، فإنها غرست جذرًا سيثمر بمبادرة السلام العربية عام 2002، حيث لعبت السعودية دور الريادة في اقتراح التطبيع مقابل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة عام 1967، ما يعكس نجاحًا غير مباشر لاستراتيجية التطبيع الهادئ التي مهدت لها إدارة كلينتون.
بوش الابن.. التطويع بالحرب:
انشغل جورج بوش الابن بحربه المفتوحة على الإرهاب أكثر من انشغاله بملف التطبيع ومعاهدات السلام في الشرق الأوسط والمحيطين العربي والإسلامي، غير أن إدارته كانت حريصة على إدارة الصراع بما يعيد تشكيل المنطقة على أسس ثلاثة:
أولها الدفاع عن الحلفاء من العرب والنظم المنخرطة في “عملية السلام” بما يضمن مصالحها وازدهار الكيان في المنطقة، وثانيها عزل ومحاصرة النظم التي تعرقل عملية السلام وتحول دون انخراط عربي ومسلم كامل في المعسكر الأمريكي بما يعنيه ذلك من تهديد لمصالح الكيان وأمنه وتمدد نفوذ قوى مناوئة للغرب، وثالثها ملف الحريات وهو ملف “أيديولوجي” كما وصفته الإدارة وقائم على التخلص من عوامل القمع والإجبار والدخول في دوامة من الحريات المدنية والاقتصادية وفقًا للتعريف الأمريكي.
ورغم أن ملف التطبيع المباشر لم يكن مطروحًا على طاولة بوش الابن، فإن خيوطًا عديدة ربطت دولًا عربية بجهود السلام، منها ما اتجه نحو بناء تحالفات لمحاربة “أعداء مشتركين”، ومنها ما تعلق باتفاقيات سلام مباشرة مثل “خارطة الطريق”، أو غير مباشر مثل مبادرة السلام العربية لعام 2002.
عمّقت الإدارة من تعاونها مع أنظمة كل من: الأردن ومصر والخليج العربي والمملكة العربية السعودية كـ”شركاء حيويين” في عملية السلام، من خلال بناء تحالفات لمحاربة التطرف والقوى الرجعية في المنطقة، وهكذا انخرط المعسكر العربي الموالي لأمريكا في حربها المفتوحة على الإرهاب ضد قوات القاعدة كواجهة لأعمالها المناوئة في الحقيقة للتمدد الإيراني وملاحقة الميليشيات والجماعات المسلحة المحسوبة على طهران.
من ناحية أخرى، تقرّبت الإدارة من دول عربية وازنة باتفاقيات تجارة حرة وضخّت أموالًا طائلة في إطار مبادرات أمريكية تستهدف المجتمع المدني ومكوناته الشابة لتدريبها في برامج السلام والتعايش والحريات، وكان للمملكة السعودية نصيب الأسد منها، إذ كانت أنظار إدارة بوش تتجه حينها بعيدًا عن الشام وشمال إفريقيا باتجاه دول الخليج العربي وعلى رأسها البحرين والإمارات وقطر ودول جنوب شبه الجزيرة: عُمان واليمن؛ حيث ربطتها باتفاقيات اقتصادية وتجارية حوّلتها إلى أنظمة موالية لواشنطن وحاملة لشعلة حضارتها ومهدت من خلالها لضم عدد من هذه الدول لقطار التطبيع.
في المقابل، زادت الإدارة ضغطها وحصارها على بغداد وطرابلس لـ”رعايتها للإرهاب” وسعيها لامتلاك أسلحة دمار شامل، وفق ما أشاعته واشنطن، بينما كانت تحاول بالأساس تحييد القوى التي من شأنها عرقلة بناء شرق أوسط جديد تسوده ثقافة التطبيع والتعايش.
ومارست إدارة بوش الابن طيفًا من الضغوطات والتهديدات ذات الطبيعة العسكرية ضد “معسكر الإرهاب” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمخض عنها الإطاحة بنظام صدام وخلع أسلحة القذافي وخلق تحالف دولي ضد إيران بفرض عقوبات أممية وأمريكية متعددة عليها.
أما فيما يتعلق بمبادرات السلام المباشرة وغير المباشرة والتي كانت محدودة أساسًا، فقد كانت إدارة بوش الابن أول من طرح فكرة الدولة الفلسطينية العرجاء في مفهوم يتردد كثيرًا تحت شعار “حل الدولتين” والذي لخصته في مشروع “خارطة الطريق”، عملت الإدارة الأمريكية على إنشاء تحالف عربي ودولي مؤيد لخطة السلام القائمة على إنشاء كيان فلسطيني مستقل لكن محدود السيادة ومنزوع السلاح وديمقراطي، دون فئاته “الإرهابية” الرافضة للتعايش مع الكيان، وكانت دول الجامعة العربية أولى المنخرطين في المعسكر التنفيذي لـ”خارطة الطريق”، حيث كان لها مشاركة فعّالة في مؤتمر أنابوليس في ميريلاند والذي جمع فيه بوش كل من محمود عباس وإيهود أولمرت بإشراف أممي دولي وعربي.
كما عقدت الإدارة محادثات مباشرة مع كل من البحرين والمملكة العربية السعودية إلى جانب الأردن ومصر كوسطاء سلام ومشرفين على تنفيذ الخارطة، بينما نصت “خارطة الطريق” على متابعة تطبيع العلاقات الإسرائيلية-السورية والإسرائيلية-اللبنانية، كآخر دول ذات حدود مشتركة مع الكيان، وما زالت غير منخرطة رسميًا في معسكر التطبيع.
قبل “خارطة الطريق” الأمريكية، قدمت المملكة العربية السعودية مبادرة السلام العربية في عام 2002 كحل نهائي للقضية الفلسطينية، والتي نالت تأييد الدول العربية في مؤتمر بيروت، حيث اقترحت المبادرة تطبيع العلاقات العربية-الإسرائيلية مقابل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لعام 1967، ورغم أن المبادرة لم تكن أمريكية، فقد دعمتها إدارة بوش الابن، ودمجتها في “خارطة الطريق” بهدف تسهيل التوصل إلى تطبيع شامل دون الحاجة لضغط أمريكي مباشر.
مبادرة السلام السعودية لعام 2002، ستُعتبر بعد عقدين من الزمن عنصرًا حاسمًا في موقف المملكة في ظل تطبيع “اتفاقات أبراهام”، لكن هذه المبادرة لم تكن الأولى، فقد سبقتها خطة ولي العهد فهد عبد العزيز في الثمانينيات، والتي تضمنت شروطًا مشابهة، كما دعمت المملكة تلك المبادرات بخطوات اقتصادية، مثل رفع الحظر عن التعاملات مع “إسرائيل” عام 1994، رغم أن الانتفاضة الثانية حالت دون تطبيع رسمي حتى ظهرت مبادرة السلام.
رغم الطموحات والآمال التي رافقت قدوم إدارة أوباما لتحقيق تقدم في ملفات الشرق الأوسط، خاصة في دعم مبادرة السلام العربية بقيادة السعودية، فإن الإدارة واجهت العديد من التحديات التي حالت دون أن تلعب دورًا مفصليًا في ملف التطبيع بالشرق الأوسط والمحيط العربي الأوسع، وتمثلت في رفض الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو تقديم أي تنازلات حقيقية، بالإضافة إلى الإرث الثقيل الذي خلفته حرب بوش على الإرهاب والملفات الأمريكية المحلية والخارجية التي تعاني من فوضى عارمة.
انضم لاحقًا إلى هذه التحديات، أحداث “الربيع العربي” والثورات التي فرضت على واشنطن تغييرًا جذريًا في أجندتها تجاه الشرق الأوسط، وهي أجندة لم يعد ملف التطبيع الرسمي على قائمة أولوياتها، وإن ظل أمن “إسرائيل” أحد أهم المحددات فيها.
كان آخر هذه التحديات صعود “الدولة الإسلامية” وبدء فصل جديد من الحرب الأمريكية على الإرهاب، وإن اتخذت أدوات مختلفة عن أدوات بوش الابن سابقًا، إلى الحد الذي دفع البعض للقول إن لا رئيس أمريكي وعد بقدر أوباما وأنجز بتواضعه في ملف السلام بالشرق الأوسط.
وبدلًا من اجتراح طريق تطبيعي جديد، سارعت إدارة أوباما لتثبيت أركان أقدم وأهم تطبيع في منطقة العرب ألا وهو التطبيع المصري، ففي منأى عن التمنع الأمريكي الظاهري للتعامل مع نظام السيسي الانقلابي بدعوى الديمقراطية واحترام إرادات الشعوب، إذ لم ترفض إدارة أوباما تسمية الانقلاب باسمه وحسب، بل حامت شبهات حول دورها في حدوثه أو على الأقل إعطائه الضوء الأخضر، فقد سارعت الإدارة للتواصل مع نظام السيسي.
كما واصلت الإدارة تزويد النظام المصري بشحنة أسلحة أمريكية ساعدته على إطباق قبضته في مصر وسيناء، وهي المنطقة التي نظرت إليها إدارة أوباما بكثير من التوجس لحساسية موقعها من “إسرائيل”، كما واصلت تزويد مصر بمساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي سنويًا، حيث تعد مصر ثاني أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأمريكية بعد “إسرائيل”.
يرجع الفضل إلى إدارة أوباما أيضًا في بذر الحصاد الذي ستجنيه إدارة دونالد ترامب بعد سنوات قليلة في “اتفاقات ابراهام” وذلك من خلال التقارب الأمريكي الإيراني الذي ثبتت أركانه من خلال الاتفاق النووي مع إيران في 2015، الذي رفع جزءًا من العقوبات عنها، وسمح لها بتعزيز وجودها العسكري في المنطقة عبر دعم الميليشيات الموالية لها.
هذا التغيير في التوازن الإقليمي أثار قلق دول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية، ما دفعها إلى تعزيز علاقاتها مع “إسرائيل”، التي كانت تشاطرها نفس المخاوف بشأن النفوذ الإيراني المتزايد، إلا أن ذلك لا يعني أن إدارة أوباما رفعت يدها عن الاستثمار الفعّال في “السلام” في دول الخليج والمملكة السعودية بالذات.
في منتصف عام 2015، نظمت إدارة أوباما قمة في كامب ديفيد جمعت خلالها قادة دول الخليج، تلتها قمة في الرياض، بهدف طمأنة هذه الدول بشأن المخاوف من إيران وتعزيز التعاون الأمني، وفي تلك الفترة، رغم الانتقادات حول انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، شهدت العلاقات الأمريكية مع دول الخليج تطورًا ملحوظًا، تحديدًا الإمارات والسعودية والبحرين.
على سبيل المثال، أبرمت الإدارة صفقة تسليح ضخمة مع السعودية بلغت قيمتها 115 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقات أصغر مع باقي دول الخليج، قُدّرت بـ33 مليار دولار أمريكي منذ 2015 وهي قيمة تعادل ثلاثة أمثال صفقات إدارة بوش العسكرية مع دول الخليج العربي بما فيها البحرين والإمارات والكويت، وتكلّلت هذه الجهود بتورط أمريكي مباشر في حرب الخليج باليمن.
في ظل تحولات جيوسياسية غير مسبوقة في المنطقة، تمكن ترامب من تحقيق ما عجز عنه سابقوه، حيث فرض أجندة سلام أمريكية في الشرق الأوسط، معتمدًا على سياسة “أمريكا أولًا” و”الضغط الأقصى”، وعزل الملف الفلسطيني عن مساعي التطبيع، ما ربط هذه الأخيرة بمخاوف أمنية واقتصادية وعسكرية لدول المنطقة، مع التركيز على مصالحها الأمنية بدلًا من تحقيق تسوية مع الفلسطينيين.
تمكنت إدارة ترامب من تحقيق اختراق تاريخي في عملية التطبيع من خلال “اتفاقات أبراهام”، حيث ضمت أربع دول عربية هي: البحرين والإمارات والسودان والمغرب في فترة قصيرة من أغسطس/آب حتى ديسمبر/كانون الأول 2020، مثيرًا حسد الرؤساء السابقين، تحديدًا غير الجمهوريين.
ورغم أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عقود من السياسة الأمريكية القائمة على الضغط الاقتصادي والتلاعب السياسي وزراعة التهديدات الإقليمية وتشجيع الجماعات الإرهابية، فإن إدارة ترامب تمكنت من التخلص من سياسة العصا والجزرة مع الفلسطينيين وسعت علانية إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال ما عُرِف بـ”صفقة القرن” في مقابل اصطفافٍ عربي غير مسبوق -على الأقل بالعلن-.
كانت سياسة ترامب المناوئة لإيران، والتي بدأت بالانسحاب من الاتفاق النووي وتطبيق حزمة من العقوبات القاسية على طهران، أسهمت بشكل كبير في تعزيز التقارب بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي التي ترى، كما “إسرائيل”، في توسع النفوذ الإيراني تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة.
مع ذلك، فإن “اتفاقات أبراهام” كانت تجسيدًا لسنوات من التعاون السري بين “إسرائيل” ودول الخليج، وبالأخص الإمارات، إذ كانت تلك الدول جزءًا من تحالف مقاطعة “إسرائيل” في جامعة الدول العربية، لكنها أدركت أن التحولات الإقليمية مثل الربيع العربي ونمو الميليشيات الإسلامية المدعومة من إيران جعلت من الضروري تغيير الاستراتيجيات، ونتيجة لذلك، بدأت الإمارات تنظر إلى “إسرائيل” وأمريكا كحلفاء أساسيين لحماية مصالحها الإقليمية.
فقد جرت تحت إشراف إدارة أوباما، لقاءات سرية بين يوسي كوهين، رئيس الموساد الإسرائيلي، ومسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى، أسفرت عن فتح مكتب دبلوماسي إسرائيلي في الإمارات عام 2015، وتلقت على إثره أبو ظبي مكافأة من ترامب عبر الضغط لعقد صفقة ضخمة لطائرات إف-35 المقاتلة، تقدر قيمتها بـ23 مليار دولار أمريكي.
ورغم أن الصفقة توقفت بعد خسارة ترامب في الانتخابات بسبب المخاوف التي أثارها الكونغرس بشأن تقارب الإمارات مع الصين وروسيا، فإنه مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، عادت الإمارات للمطالبة بتنفيذ الصفقة العسكرية التي كانت قد وعدت بها الإدارة الأمريكية.
بالمثل، فقد جمعت البحرين علاقات سرية بالحكومة الإسرائيلية برعاية أمريكية، تمخضت عن رفع ملك البحرين لسياسة المملكة المشتركة مع العرب بمقاطعة “إسرائيل” عام 2017، بينما سبقت هذا القرار الزيارة الأولى لوفد إسرائيلي للمملكة بأكثر من عقدين ونصف.
كما استضافت البحرين في ظل إدارة ترامب مؤتمر “الازدهار من أجل السلام”، الذي سوّق لصفقة القرن ومكانة مدينة القدس في “الديانة الإبراهيمية” المريبة، وذلك وسط غياب القيادات الفلسطينية التي رفضت المشاركة بعد إعلان ترامب المدينة المقدسة عاصمة موحدة وأبدية لـ”إسرائيل” ونقل السفارة الأمريكية إلى أراضيها.
جاء هذا المؤتمر الذي رفع اللثام عن تعاون أمريكي-خليجي اقتصادي في المستقبل القريب بعد أشهر قليلة من حزمة مساعدات قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة للمنامة بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، ما أثار شبهات عديدة حول الدور الذي لعبته أبو ظبي والرياض بدفع البحرين إلى أحضان التطبيع المشهر رغم تمنع الرياض عن الانضمام العلني لحسابات مختلفة.
لا يخفى كذلك الدور الذي لعبته إدارتا أوباما وترامب بدعم البحرين في مواجهة المعارضين إبان ما كان يمكن أن يتحول لثورة حقيقية ضد النظام الحاكم على غرار مصر وتونس وسوريا، لولا التدخل السعودي والأمريكي الذي سحق طلائع الثورة دون رحمة وظل شبح الأحداث ومَن قد يتلقفها، خاصة إيران، يلاحق الأسرة المالكة حتى دفعها للاحتماء بالركن الإسرائيلي-الأمريكي من خلال التطبيع الرسمي.
بينما عرض ترامب تسويات سياسية كانت في حاجة إليها كل من السودان والمغرب في ظل النزاعات الداخلية التي كانت تعصف بهما بالتزامن مع “اتفاقات ابراهام”، فقد حصلت الحكومة السودانية على وعد من ترامب برفعها عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، فيما حصل المغرب على دعم أمريكي للاعتراف بأحقية سيادته على الصحراء الغربية، وهنا يتبدى الدور الأمريكي الخبيث في المنطقة والذي يشتري ولاء الدول ومواقفها من “إسرائيل” في مقابل دعم ادعاءاتها ومصالح حكوماتها في مواجهة المعارضين والقوى المتنازعة حولها.
ومع عودة ترامب للبيت الأبيض، يطفو تهديد مباشر بعقد الصفقة التي عجز عنها جو بايدن، وهي جرّ المملكة العربية السعودية لحظيرة التطبيع الرسمية، خاصة إذا استأنف ترامب صفقته العسكرية مع المملكة التي بدأها قبل مغادرته، والتي كانت تشمل بيع أسلحة للمملكة بقيمة 110 مليارات دولار على امتداد 10 سنوات قادمة، والتي تعرقلت بسبب قدوم بايدن للحكم.
عانت إدارة بايدن من انتقادات تتعلق بـ”الضعف والتلكؤ” في مواجهة القضايا المصيرية التي خلفتها سياسة ترامب، بسبب سياسة “الضغوط القصوى” التي خلفت توترات في العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك دول الخليج، ما جعل إدارة بايدن تواجه تحديات كبيرة في إعادة ترتيب هذه العلاقات واستئناف مسار التطبيع في المنطقة.
ورغم أن إدارة بايدن قدمت بآمالٍ عِراضٍ لاستئناف ما بدأه ترامب من تطويع المنطقة العربية وإعادة تشكيل الشرق الأوسط، فإن تصاعد الضربات الإسرائيلية المتتالية على قطاع غزة في 2021 و2023، والتي أطلقت حربًا إبادية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، شكلت تحديات كبيرة أمام سعيه لضم المملكة السعودية إلى قطار التطبيع، وهو ما كان بايدن يأمل بقطف ثماره قبل أن يغادر منصبه، ورغم محاولات الوصول إلى وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى بين حماس و”إسرائيل”، فإن الإدارة لم تتمكن من إتمام اتفاق تطبيع مع السعودية، ما جعل تلك الجهود تظل غير مكتملة بنهاية ولايته.
بالإضافة إلى الضربات الإسرائيلية على غزة، كانت سياسة بايدن التي سعت لإيجاد تسويات مع طهران ورفع بعض العقوبات من أجل إحياء الاتفاق النووي أحد العوامل التي أثارت قلق المملكة السعودية ودول الخليج، فقد حاول بايدن التوصل إلى حلٍ وسطي مع طهران بعددٍ من الاتفاقات الجانبية التي خففت العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب في مقابل استئناف مستقبلي للاتفاق النووي الذي عقده أوباما وتنصل منه ترامب، وذلك قبل “طوفان الأقصى”.
كما أن إدارة بايدن، التي ركزت على ملفات روسيا والصين، وجدت نفسها في مواجهة تحديات كبيرة مع دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، فمن جهة واجهت انتقادات من بايدن بشأن قضايا مثل صادرات النفط والحرب في اليمن، ما أسفر عن توتر العلاقات بين الجانبين، جعل من الصعب على بايدن المضي قدمًا في مسار التطبيع السعودي.
مع ذلك، شهدت العلاقة تحسنًا بعد فشل جهود إحياء الاتفاق النووي مع إيران والعقوبات الروسية التي أثرت على قطاع الطاقة، كما أسفرت زيارة بايدن لمحمد بن سلمان في 2022 عن توقيع عدة اتفاقيات في مجالات الصحة والأمن السيبراني والاستكشافات العلمية، بالإضافة إلى اتفاقيات عسكرية لتعزيز القوة الجوية السعودية، ورغم هذه التفاهمات، ظل ملف تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” معلقًا.
في سياق آخر، حالت إدارة بايدن دون إتمام صفقات بيع أسلحة للإمارات كانت قد أقرتها إدارة ترامب سابقًا، بدعوى التقارب الروسي والصيني مع الإمارات، حيث أشارت تقارير إلى هذا التقارب الاقتصادي، ما أثار شكوكًا أمريكيةً في صدق نوايا أبو ظبي والدور الذي ستلعبه في الساحة الدولية مستقبلًا.
من جهتها، رأت الإمارات في تنامي التقارب بين إدارة بايدن وقطر دورًا في تسهيل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، ما يعارض دعم واشنطن للحصار الذي فرضته الإمارات وبقية دول الخليج على قطر عام 2017، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 2020، جددت إدارة بايدن علاقتها مع أبو ظبي بتسميتها “شريك دفاع أساسي”، دون إقرار صفقة الطائرات “إف 35” التي أبرمتها إدارة ترامب.
رغم ثناء وتعهد بايدن بمواصلة وتعميق تأثير “اتفاقات أبراهام” خلال أيام انتخابه الأولى، فإن جهوده لم تثمر على أرض الواقع بسبب تغير اتجاه الريح في الشرق الاوسط برمته، وظهور عدد من التحديات على الساحة الدولية تركت إدارة بايدن في وسط حالة من الفوضى وتركة ترامبية ثقيلة يبدو أنها في طريقها للعودة الآن.


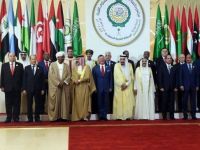
ارسال التعليق